السؤال
سؤالي هو: أقوم بعمل لشخص ما، وعملي هو كتابة السير الذاتية للناس، ثم أقوم بإرسال تقرير لصاحب العمل أبين فيه المبالغ المستحقة لي ـ الراتب ـ فحصل بيننا خلاف على حساب السعر لسيرة ذاتية معينة. حيث مثلا المفروض أن يعطيني 100 بدلا من 80 درهما حسب اتفاقنا المبدئي للعمل، وقد وضحت له أن هذا ظلم. ولكنه مصر على رأيه، وقال لا أريد أن أناقش هذا، ويريدني أنا أحاسبه عليها بسعر 80 وهذا ظلم، فقررت أن لا أقبل هذا علي، فقلت في نفسي إنني سأقوم بعملها دون أن أحاسبه عليها، وأعتبرها صدقة لله، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وما يحيرني هو أنني أحس أنني عندما أعمل هذا بأنه ليس صدقة، وإنما هو عناد لصاحب العمل، ولكي أجعله يرتدع عن مثل هذا الظلم، وأحس أنني أقهره بهذا العناد، علما بأنني قد أرسلت له كشف الراتب، وخصمت بالكامل المبالغ التي بها ظلم، ولم أحاسبه كما يريد، ولم أجد أي رد أو اعتراض من ناحيته، فأريد منكم أن تصوبوني، فهل يعتبر هذا العمل من عزم الأمور؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين* ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم* ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور{ 40ـ 43} وهل يفضل أن أحاسبه على 80 درهما، وأصبر على هذا الظلم، وأقول في نفسي: إن الله سيجازيني يوم القيامة؟ أم أخصم المبلغ بالكامل، وأعتبرها صدقة على هذا الشخص لله؟
وهل أعتبر من الظالمين إن كنت أعمل مع شخص يظلم الناس؟ وهل يجب علي أن أترك العمل؟ أم أن أبقي فيه إذا كان للضرورة؟
مع العلم أنني أحاول أن أنصح صاحب العمل قدر المستطاع؟.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

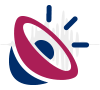

 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات