السؤال
فضيلة المشائخ: يقول الله تعالى في سورة الأعراف آية 12 مخاطبا إبليس: (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ويقول سبحانه في سورة ص آية 75: (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي). ما في سورة ص نفي النفي، وهذا إثبات لامتناع السجود من إبليس.
فما معنى كلامه تعالى في سورة الأعراف حين نفى سبحانه نفي النفي، لِم لمْ يكن الإعراب إثباتا للسجود في الآية الكريمة؟
أفتونا وفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوال، ومن أبرزها ما جاء في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمؤلفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث قال: قوله تعالى: {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} الآية. في هذه الآية إشكال بين قوله: {منعك} مع (لا) النافية؛ لأن المناسب في الظاهر لقوله: {منعك} بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف (لا) فيقول: "ما منعك أن تسجد" دون "ألا تسجد" وأجيب عن هذا بأجوبة؛ من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه، وعليه فالمعنى: ما منعك من السجود، فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير: "إنه حسن قوي".
ومن أجوبتهم أن (لا) صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة (ص): {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} الآية، وقد وعدنا فيما مضى أنا إن شاء الله نبين القول بزيادة (لا) مع شواهده العربية في الجمع بين قوله: {لا أقسم بهذا البلد} وبين قوله: {وهذا البلد الأمين}. اهـ.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وما للاستفهام، وهو استفهام ظاهره حقيقي، ومشوب بتوبيخ، والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة. ومنعك معناه صدك وكفك عن السجود، فكان مقتضى الظاهر أن يقال: ما منعك أن تسجد؛ لأنه إنما كف عن السجود لا عن نفي السجود، فقد قال تعالى في الآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي [ص: 75] ، فلذلك كان ذكر (لا) هنا على خلاف مقتضى الظاهر، فقيل هي مزيدة للتأكيد، ولا تفيد نفيا؛ لأن الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير التأكيد. و (لا) من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام؛ كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد [البلد: 1]- وقوله- لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله [الحديد: 29]. أي ليعلم أهل الكتاب علما محققا. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون [الأنبياء: 95]. أي ممنوع أنهم يرجعون منعا محققا، وهذا تأويل الكسائي، والفراء، والزجاج، والزمخشري، وفي توجيه معنى التأكيد إلى الفعل مع كون السجود غير واقع، فلا ينبغي تأكيده خفاء؛ لأن التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد، فلا ينبغي التعويل على هذا التأويل. وقيل (لا) نافية، ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه منعك؛ لأن المانع من شيء يدعو لضده، فكأنه قيل: ما منعك أن تسجد فدعاك إلى أن لا تسجد، فإما أن يكون منعك مستعملا في معنى دعاك، على سبيل المجاز، و (لا) هي قرينة المجاز، وهذا تأويل السكاكي في «المفتاح» في فصل المجاز اللغوي، وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه، وهو أحسن تأويلا، وإما أن يكون قد أريد الفعلان، فذكر أحدهما وحذف الآخر، وأشير إلى المحذوف بمتعلقة الصالح له فيكون من إيجاز الحذف، وهو اختيار الطبري ومن تبعه. اهـ.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

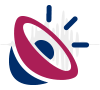
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات